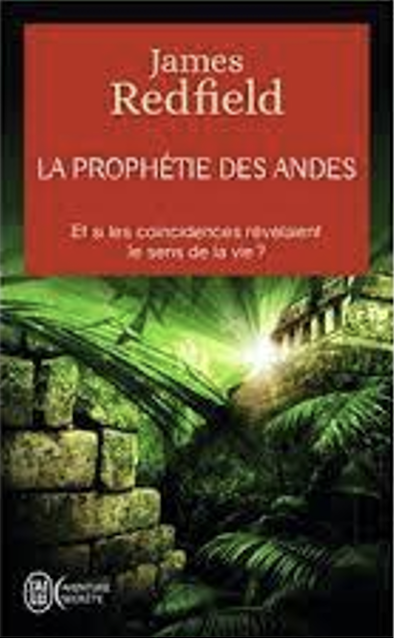مقدمة
الجبل ليس غريبًا عن الإبداع الفني والأدبي، وليس بعيدًا عن علاقته بالإنسان في مختلف حقباته الزمنية، فكثيرًا ما جعل منه سندًا قويًا في حياته؛ يُنظر إليه بعين من الكبرياء والطمأنينة بسبب حضوره المهيب والمستقر في الأفق، أو لانتمائه إلى تضاريسه الجغرافية الشامخة في السماء. ومهما كان موقع الجبل، ومهما كانت طبيعته التي تكوّنه، كالغابات أو الصخور أو الأرض القاحلة في الصحراء، فإنّ الأثر الذي يتركه في الذين عاشوا وترعرعوا في حضنه يبقى واحدًا، مع تنوّع في أبعاد التلقي والتمثل الجمالي له؛ فمنهم من يتمتع بطبيعته التي رآها منذ ولادته، ومنهم من هاجره فيجعله في مخزن الذكريات حنينًا إليه وإلى من تجمعه الصلة الحميمية معهم، ومن الأشخاص من ينظر إلى الجبل بدرجة من التقديس، لا يستطيع مفارقته.
وإذا كانت الرمزية الشعرية للجبل حاضرة في الشعر قديمه وحاضره، عبر الأزمنة المتعاقبة، فإنّه حاضر كذلك في الخطابات السردية كالقصة والرواية. فالموضوعات في الأجناس الأدبية المختلفة تكاد تكون نفسها، مع تغيّر في أساليب عرضها، وتغيّر في المواقف والرؤى إزاءها. ففي الروايات الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية والتي يحضر فيها الجبل بقوة؛ رواية مولود فرعون الموسومة (Les chemins qui montent) أو (الدروب المتصاعدة)، ورواية مولود معمري (La colline oubliée) أو (الربوة المنسية)، وهما نصان يحوّلان الجبل إلى عنصر بنيوي محوري في بناء الشخصية والحدث والهوية. كما نجد الجبل في روايات أخرى في الآداب الأجنبية والعالمية مثل رواية (La prophétie des Andes) أو (نبوءة جبال الآنديز) للكاتب الأمريكي جيمس ريدفيلد (James Redfield)، التي وقع عليها اختيارنا لهذه الدراسة، اعتمادًا على المنهج البنيوي الذي ينطلق أساسًا من البنيات اللغوية للخطاب في مستوياته المتعددة، ليصل إلى عمق الدلالات النهائية المحتملة.
تنتمي هذه الرواية إلى ما يُعرف بالجغرافيا الأدبية، حيث يندمج المكان الواقعي بالجبل مع البناء الرمزي والتخييلي للنص السردي. ويظهر الخطاب الروائي فيها متعلّقًا بالمكان الجغرافي الحقيقي، المتمثل في جبال الأنديز الواقعة غرب أمريكا الجنوبية، ففيها تتحرّك أحداث الرواية، ومنها ينطلق مسار السرد، وفيها تأسّس موضوعها الذي يرصد عددًا من المغامرات والاكتشافات، التي تواكب موضوع البحث عن النبوءة الجديدة.
أما عن إشكالية بحثنا، فهي تتلخص في جملة من الأسئلة الجوهرية، أهمها : ما الذي يجعل من الجبل في هذه الرواية بنية دلالية مركزية؟ ولماذا اختار الكاتب جبال الآنديز مكانًا رئيسًا للرواية؟ وكيف تجسّد حضور الحقل السيميائي للجبل؟ وما خصائص البنيات السردية وعلاقاتها بمحور الفضاء/الجبل في هذا الخطاب التخييلي؟
اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي، وهو منهج كثير التوظيف في الدراسات الإنسانية والأدبية، نظرًا لتنوّع ظواهرها وصعوبة التجريب فيها، وانفتاح التحليل على إمكانات جديدة يصعب الإمساك بها بالأساليب العلمية والمنطقية البحتة. كما أنّ هذا المنهج يدرس الظواهر أو القضايا في آنيّتها ولحظات تبلورها، ويمكنه استشراف تطورها وتحولاتها المستقبلية.
أما عن المنهج النقدي الذي تم توظيفه في هذا المقال، فيتمثل أساسًا في المنهج البنيوي الذي ينطلق من بنية النص اللغوية والتركيبية، وسياقاته الداخلية، لا سيما وأنّ الخطاب خطاب سرديّ، متعدد المستويات والعلاقات. كما يقوم هذا المنهج على الكشف عن العلاقات الرابطة بين البنى المختلفة للخطاب وعناصره المتعددة. وقد تم تدعيم هذا المنظور البنيوي بمقاربات سيميائية وتأويلية، خاصة في تحليل عتبات النصوص الموازية، مع التركيز على رمزية الغلاف والعنوان كمدخل تأويلي للنص. بالإضافة إلى ذلك، يلعب عنصر التأويل دورًا هامًا في التفسير والتحليل لتلك الرموز والشفرات التي يحملها النص.
1. بنية النص الموازي للرواية
1.1. الغلاف / الواجهة
تشكل واجهة غلاف الرواية (La prophétie des Andes) (Redfield, 1996) وحدة دلالية سيميائية مرئية، تؤدي وظيفة تمهيدية للمقروء، إذ تمنح المتلقي دلالات أوّلية عن موضوع الرواية بشكل عام. فالكاتب قد يركّز في الغلاف على علامات وشفرات معيّنة دون غيرها، ويقترح بذلك مدخلاً تأويليًا مبدئيًا لما تحمله الرواية من رؤى. يقول شوقي مجدولين في هذا السياق :
« هذا التوظيف لا يمكن أن يُدخل اللغة في لعبة جديدة لا مجال فيها للتواصل، ولا أهمية كبرى فيها للاحتراف الكاليغرافي. إن المعطى اللغوي والحرفي يتحوّل إلى عنصر مرئي مجرّد من مركزية مدلولاته، ليأخذ أبعادًا جديدة يكتسبها من اندماجه في فضائه الجديد ونسيجه البصري » (مجدولين، 2009 : 157).
الصفحة الأولى (الواجهة) من الرواية.
يُظهر الغلاف في روايتنا هذه صورة قاتمة لأدغال كثيفة وصخور داكنة، يخترقها درب ضيق متعرج بين الأشجار والنباتات، حيث تُوحي هذه الصورة بصعوبة المسلك ووحشة العبور. فالنبوءة – كما يتخيّلها الكاتب – ليست أمرًا هيّنًا، بل رحلة محفوفة بالعقبات والمخاطر. هذا التصور البصري يُذكّرنا برمزية المعاناة التي مرّ بها الأنبياء والمرسلون في قصصهم المتداولة في القرآن الكريم وكتب التاريخ والمعتقدات.
في أعلى هذا الدرب، وفي وسط الأدغال المعتمة، ينبثق ضوء أبيض ناصع يشعّ من بناية شاهقة تشبه في هندستها معبدًا روحانيًا، يرتكز على الأقواس والعلوّ، كما هو مألوف في هندسة المعابد في ثقافات شتّى. يمثل هذا النور « نور النبوءة »، أو ما يمكن اعتباره هداية رمزية أو كشفًا داخليًا يطمح الكاتب إلى استحضاره. فكل نبوءة تنطوي على رؤية كونية عميقة، وموقف فلسفي تجاه الوجود والإنسانية.
إن هذا الضوء ليس مجرد عنصر زخرفي بصري، بل هو تعبير مكثّف عن الجوهر الذي تسعى الرواية إلى كشفه. وسيتضح هذا عندما نتتبع فصول الرواية، حيث يظهر أن السارد، بعد مسار طويل مليء بالتحديات، يصل تدريجيًا إلى اكتشاف ما يُعرف في النص بـ« الاعترافات التسعة »؛ وهي نصوص نبوئية قديمة غامضة تتطلب مجهودًا روحيًا وفكريًا بالغًا للوصول إليها.
2.1. عتبة العنوان
يُعد العنوان أولى عتبات النص التي يلج من خلالها القارئ، وأولى المفاتيح التي يمنحها لنا المؤلف، حيث يقول ضمنيًا : « هكذا أريد أن يُقرأ النص، وهكذا أحدد مدخله التأويلي الأول ». ولا تتمثل أهمية العنوان في تسمية النص أو الإشارة إليه من أجل أن يكون متميزًا عن النصوص الأخرى فحسب، بل للعنوان حمولة دلالية مركّزة تختزل المضامين الأساسية في النص. يقول الجزار في هذا السياق : « ويُعدّ نظامًا سيميائيًا ذا أبعاد دلالية وأخرى رمزية » (الجزار، 1998 : 15)، لما يتّسم به من اختزال واقتصاد لغوي. ومن جهة ثانية، يُعد العنوان
« مفتاحًا أساسيًا يتسلّح به المحلّل والناقد للولوج إلى أغوار النص العميقة، قصد استنطاقها وتأويلها » (مفتاح، 1990 : 72)،
أو « مفتاح الدلالة الكلية التي يستخدمها الناقد مصباحًا يضيء به المناطق المعتمة في النص » (نفسه).
وضع الكاتب عنوانه الرئيس في وسط السطر وفي أعلى الصفحة، بخط كبير وواضح، وباللون الأبيض، وهو اختيار بصري ذو دلالة رمزية وجمالية، ما يجعل القارئ يحيل عليه مباشرة عند رؤية الواجهة. وللعنوان وظائف كثيرة لخّصها جيرار جنيت في كتابه عتبات، حيث يرى أنها تتمثل فيما يلي :
« وظيفة تحديدية Fonction de désignation أو تعريفية Fonction d’identification، وتتعلق ضمنيًا بالتّسمية لا غير، ووظيفة وصفية Fonction de description، ويؤديها العنوان وفق العلاقات التي تربطه بمداخل النصّ وموضوعه الذي تأسّس من أجله، فهو وطيد الصلة به وبشكل مباشر، ووظيفة إيحائية Fonction de connotation، وتعدّ هذه الوظيفة فنية وجمالية، لا تسمّي النص ولا تصفه بقدر ما تلمّح لشيء بداخله. وأخيرًا، الوظيفة الإغرائية Fonction de séduction، وتتعلق بما هو إشهاري وبوساطتها يكتسب النص جاذبية عند القرّاء نحوه ويشدّهم إلى إدراكه والاهتمام به » (Genette, 1987, pp. 87–89).
يُعتبر العنوان بوابة الدخول الأولى إلى عوالم النص، وعنصرًا تأويليًا موجّهًا، يختاره المبدع وفق تصوراته ورؤاه، إذ يعمد في محاولته إلى اختزال النص إلى مجرّد ملفوظ بسيط في تركيبه النحوي أو في بنيته اللغوية أو الإشارية. ويعتمد الكاتب فيه خاصية التكثيف، وهي سمة رئيسة في العنونة، يحاول من خلالها أن يختزل البنية الدلالية للنص في دلالية العنوان. وغالبًا ما يلجأ إلى الرمزية أو التلميح دون الكشف المباشر، مما يحمّل العنوان طاقة تأويلية عالية (سعدوني، 2018 : 29).
وإذا نظرنا إلى عنوان الرواية (La prophétie des Andes)، فهو عنوان بقدر ما يشير إلى مضمون الرواية ويلخصه، فهو في الآن ذاته عنوان ذو طابع إغرائي وتسويقي يحمل بعدًا تأويليًا غامضًا. فـ« النبوءة » كلمة قوية ذات حمولة ميتافيزيقية وروحية، لا يمكن تناولها ببساطة، بل تضع الكاتب في مقام المعالج لقضايا فلسفية كبرى تمس جوهر الوجود الإنساني. ولذلك، ينبغي أن يتم تناولها بجدية وتفكير عميق. لأنّ الكاتب يبحث – لا محالة – عن مشروعية تخييلية وفكرية لخطابه الروائي. والأمر كذلك بالنسبة للقارئ، الذي يستشرف مسبقًا ما يمكن أن يرد في الرواية، ويتساءل : هل ثمة نبوءة جديدة لهذا العالم المليء بالاضطرابات والتوترات والقلق الوجودي؟
وجعل الكاتب (أو مصمم الغلاف) لون العنوان أبيض، وهو لون يرتبط بالصفاء والنقاء والنور، وهي خصائص تُنسب رمزيًا للنبوءات أو الرؤى الكاشفة. فالمعتقدات والأديان السماوية أو غيرها، تتميز في تمثلات المؤمنين بها بالنقاء والطهارة، رغم اختلافاتها.
ويأتي العنوان الفرعي المصاحب للعنوان الرئيسي توضيحًا لما تحمله الرواية في فصولها وأجزائها، ويمنح القارئ مدخلاً تأمليًا نحو لبّ النبوءة المفترضة. وكان ملفوظ هذا العنوان الفرعي : (Et si les coïncidences révélaient le sens de la vie ?) أو (وإذا الصُّدف تكشف عن معنى الحياة؟). الموضوع هنا يتمثل في نظرة الكاتب إلى الصدف التي تحدث في حياة الناس والمجتمعات، فهي في كثير من الأحيان مصدر للتغيرات المفصلية في حياة الإنسان، سواء كانت سلبية أو إيجابية. ويقول المثل الشهير : « رُب صدفة خير من ألف ميعاد »، للدلالة على الطابع المفاجئ والخلاق لبعض الأحداث غير المتوقعة. ويقول الكاتب في مقدمة روايته وهو مقتنع بفكرته :
« عندما ندرك جيدًا ماذا يحدث في الحقيقة، وعندما نعلم كيف نُحدث هذه الصُّدف ونقوّي نتائجها، عندئذ سيقفز عالم الإنسان إلى عالم جديد للحياة التي تحلم بها الإنسانية منذ الأزل » (Redfield، 1996 : 07).
إن اختيار الجبل كمكان لرؤية الصدف، لا يخلو من دلالة رمزية قوية؛ فالدروب المتعرجة والملتوية، والطبيعة الوعرة وغير المأهولة، هي بيئات حاضنة للمفاجأة والمجهول. كما أن الغابات الكثيفة والأدغال تولّد لدى المتجوّل فيها شعورًا بالضياع والانكشاف على غير المتوقع؛ سواء أكان ذلك خطرًا طبيعيًا أم كشفًا روحيًا، من مواجهة مع حيوان مفترس إلى الوقوع في وادٍ عميق، أو اكتشاف صدفة تقلب المصير.
2. تجليات سردية الجبل
1.2. الجبل كبنية جغرافية ودلالية
يُعدّ الجبل من التضاريس الهامة في علم الجغرافيا، لما يحمله من خصوصيات وتنوّعات بين أقطار العالم المختلفة؛ فلكل منها طبيعته ومناخه وارتفاعاته وعلاقاته بالتضاريس والعناصر الطبيعية الأخرى، وبالإنسان كذلك. لكن علم الجغرافيا – رغم دقّته –
« لا يعطي إحساسًا بالمكان كما يعطيه الأدب، فالنص الأدبي يتفوّق على الجغرافيا من خلال أسلوبه الجمالي والإبداعي في السرد والوصف؛ فالجغرافيا تصف الأماكن بالخرائط والبيانات، أما الأدب فهو يرسم الأماكن ويصفها بالكلمات، التي تعطي إحساسًا بروح المكان وقيمته. وتلك النصوص ذات البعد الجغرافي تحمل القارئ غالبًا إلى البحث في كتب الجغرافيا عن تلك الأماكن » (إسماعيل، 2014 : 46–47).
بهذا المعنى، يتحوّل الأدب إلى وسيلة لإعادة اكتشاف الجغرافيا من منظور وجداني وتخيّلي.
تُعتبر رواية (نبوءة جبال الأنديز) من النماذج الواضحة للأدب الجغرافي، حيث تشكّل الجغرافيا ليس مجرد خلفية للأحداث، بل مكوّنًا أساسيًا في بناء المعنى والتوجيه السردي. ولا يُطلق هذا التصنيف « إلا على الأعمال الأدبية التي تكون تحت الهيمنة الكاملة للجغرافيا كفكرة »، أي أن الأفكار والثيمات الجغرافية تُهيمن على مجريات الأحداث، وتؤسس للجو العام للنص، كما هو الحال في أدب الرحلة وأدب المغامرات. وهو عكس المشاركة العادية والتقليدية للجغرافيا، حيث تُستخدم كمحاكاة سطحية للمكان (إسماعيل، 2014 : 48–49).
اختيار الكاتب للمكان الجغرافي بوصفه عنصرًا مهيمنًا ليس اعتباطيًا، بل ينبع من ضرورته في تجسيد الموضوع والمضمون الفلسفي للرواية. لذلك فإن
« القيمة الجمالية للنظرية الجغرافية للأدب تظهر في البحث عن الأماكن المتعددة التي تتنقل فيها أحداث النص، وعن التفاصيل الجغرافية التي تتوزع بين الكاتب السارد والشخصيات » (إسماعيل، 2014 : 77–78).
وتشمل هذه التفاصيل المسميات، الأحداث، الصفات الجغرافية، الجنسيات، فضلاً عن الأفعال المكانية مثل الإبحار، الترحال، الانتقال، الصعود، والمغامرة. ويتم كذلك توثيق المكان من حيث موقعه وتضاريسه ومناخه وطبيعته، سواء كانت غابية أم صحراوية (إسماعيل، 2014 : 94–100).
يمكن تقسيم العلامات الجغرافية إلى « مؤثرة » و« غير مؤثرة »، بحسب درجة تأثيرها في بناء المعنى داخل السرد. ويُركّز هذا التحليل على العلامات المؤثرة لأنها تُشكّل بنية دلالية فعالة على مستوى السرد والشخصيات. وفي ضوء ذلك، يجدر النظر بعمق إلى الفضاء الذي تشغله جبال الأنديز في هذه الرواية، لا كمكان خارجي فقط، بل كبنية تخييلية ذات طابع روحي وثقافي مركزي.
« جبال الأنديز » المشهورة هي سلسلة جبلية واسعة ممتدة على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، يقارب طولها 7,100 كيلومتر، وعرضها 500 كيلومتر، ومعدل ارتفاعها 4,000 متر. تمتد السلسلة عبر سبع دول : الأرجنتين، الإكوادور، بوليفيا، البيرو، التشيلي، كولومبيا، وفنزويلا. ويُقال إن سبب التسمية يعود إلى نشاط أحد أنواع البراكين المسمّاة بـ« الأنديزيت »، الذي ساهم في تكوين تلك الجبال. وتُعد سلسلة جبال الأنديز الأعلى خارج قارة آسيا، حيث تصل أعلى قممها، وهي قمة أكونكاغوا، إلى ما يقارب 7,000 متر فوق مستوى سطح البحر. وإن لم تنافس جبال الهملايا في الارتفاع، فهي – تقريبًا – ضعفها من حيث الطول (نجم، 1990 : 17–18).
2.2. الجبل وموضوع النبوءة
يشكّل الجبل في الرواية الفضاء المثالي لنشوء الرؤى النبوئية والكشف الروحي والفلسفي. إنّ اختيار الروائي لهذا النوع من الأماكن الخالية والبعيدة كان صائبًا، بما يتناسب مع طبيعة موضوع الرواية : النبوءة أو الكشف عن أشياء نادرة وغامضة. و« المكان اللامتناهي » – كما يصفه يوري لوتمان – هو ذلك الفضاء غير الخاضع للسلطة، مثل الصحراء، حيث يغيب التنظيم الاجتماعي وتنسحب الدولة، فتتحوّل هذه الأماكن إلى أساطير بعيدة. وغالبًا ما تفتقر إلى الطرق والمؤسسات الحضارية، وتبتعد عن مراكز السيطرة، فتصبح مواقع رمزية للتجاوز والانعتاق، مثل غابات الأمازون، أو صحراء الربع الخالي، أو القطب الجليدي (لوتمان، 1987 : 62).
ترتبط المعتقدات الدينية والروحية في معظم الثقافات بالعزلة الجبلية، أو بالمكان المرتفع عن الأرض، حيث تتوافر ظروف التأمل والتجلي. الجبل هنا يصبح مقامًا للخلوة، واستبطان الذات، واستقبال الإلهام. ومن أبرز الأمثلة التاريخية : خلوة الرسول محمد ﷺ في غار حراء بجبل النور بمكة، حيث نزل عليه الوحي أول مرة. وكذلك موقع القدس الشريف، المبني على سلسلة جبلية في وسط فلسطين، والذي يشكّل فضاءً روحيًا مقدّسًا في الديانات الإبراهيمية.
وقد نشأت معظم الأديان الكبرى والمعتقدات من شرق العالم : الإسلام في الجزيرة العربية، المسيحية في القدس، والبوذية في الهند. بينما لم تُعرف معتقدات روحية كبرى منشؤها الغرب الأمريكي. وهذا ما دفع الكاتب جيمس ريدفيلد إلى تخيّل نبوءة جديدة في الغرب، في جبال الأنديز تحديدًا، كمكان ميتافيزيقي بديل، تتجلّى فيه رؤيا جديدة للحياة والعلاقات البشرية. فاختار لذلك فضاءً جبليًا شامخًا، يربط عدة دول، ويتسم بتضاريس متنوعة ومركبة. هذا الفضاء يوفّر شرطَي العزلة والسكينة، لكنه يحمل في عمقه رمز الحرية أيضًا، كما يوضح لوتمان : « الحرية هي مجموع الأفعال التي يستطيع الإنسان أن يقوم بها دون أن يصطدم بحواجز أو قوى خارجية لا يستطيع تجاوزها » (لوتمان، 1987 : 62).
لم تتم الإشارة في الرواية إلى اختراع نبوءة جديدة بالكامل، بل تتمحور المغامرة حول الكشف عن نبوءة قديمة تعود إلى ما قبل الميلاد. وفي أحد الحوارات، تسرد شخصية « شارلين » قائلة :
« أثناء إقامتي هناك، بجامعة ليما، لم أتوقف عن سماع إشاعات متعلقة باكتشاف مخطوط قديم جدًا؛ لكن لا أحد استطاع أن يدلني أكثر من ذلك، وحتى علماء الآثار أو علماء الأنثروبولوجيا. وفي المكاتب الحكومية نفي تام لهذا الأمر... ويعود المخطوط إلى سنة 600 قبل الميلاد » (Redfield، 1996 : 12–19).
هنا تتقاطع السردية الروائية مع سردية المجهول التاريخي، وتتحول النبوءة إلى مادة سردية تستدعي الرحلة والكشف والاستبصار.
3.2. الجبل ووصف الطبيعة
يرتبط الوصف ارتباطًا شديدًا بظاهرة السرد، خاصة إذا كان متعلّقًا بالأدب الجغرافي؛ أي عندما يكون الفضاء المكاني ليس مجرد خلفية للأحداث، بل مسرحًا حيًّا يتفاعل مع الشخصيات والوقائع، ويصبح جزءًا من الموضوع نفسه. في هذه الحالة، يأخذ الوصف بعدًا بنيويًا يُسهم في خلق دلالات متراكبة، ويُضفي على النص دينامية سردية وحركية دائمة. فكلّما توسّع الكاتب أو السارد في الوصف، كلّما عرّج على أماكن وأحداث وأزمنة وشخصيات جديدة، مما يوسّع فضاء الحكي ويفتحه على إمكانات تخييلية متجددة.
يقوم الوصف في العمل السردي بوظيفتين أساسيتين، كما يبيّن لحميداني :
« أولًا جمالية؛ ويقوم في هذه الحالة بعمل تزييني، وهو يشكّل استراحة في وسط الأحداث السردية، ويكون وصفًا خالصًا لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكي. وثانيًا توضيحية تفسيرية؛ أي تكون للوصف وظيفة رمزية دالّة على معنى معيّن في إطار سياق الحكي » (لحميداني، 1991 : 79).
بالتالي، لا يكون الوصف ترفًا لغويًا أو إطنابًا بلاغيًا، وإنما أداة تحليلية تعمّق إدراك القارئ لمعاني النص، وتضيء ما قد يُخفيه السرد من رموز أو مؤشرات.
في رواية (نبوءة جبال الأنديز)، ظهرت صور وصفية كثيرة، وظّف فيها الكاتب عنصر الوصف بأساليب متعددة، سواء في وصف الأحداث أو الطبيعة أو الأشخاص، بل وحتى في شرح بعض المفاهيم الفلسفية التي تزخر بها الرواية. والمثير للانتباه هو مدى ملاءمة تلك الأوصاف لموضوعي الجبل والنبوءة في آن واحد، إذ لم يأت الوصف هنا كأداة تصويرية محضة، بل كرافعة انفعالية ودلالية في آنٍ واحد.
يشير محفوظ إلى أنّ الوصف
« يتيح من خلاله الروائي تدفّق انفعالات داخلية تختلج في نفسية الشخصية، أو بمعنى آخر، يكون رديفًا لسبر الأغوار الداخلية لها، وهي تنفعل تحت تأثير حدث ما، حيث يتم التعبير بواسطة المشهد عن الإحساس المرافق لهذا الحدث » (محفوظ، 2009 : 58).
بهذا الفهم، يُوظّف الوصف في الرواية كوسيلة لنقل الحالة الشعورية العميقة المرتبطة بالمكان، وليس فقط لتقريب الصورة بصريًا.
في أحد المقاطع، يقول السارد :
« كنا محاصرين بالمروج والحقول الملوّنة، والحشائش تبدو غير عادية؛ شديدة الاخضرار ومتينة، تنمو حتى تحت أشجار الصنوبر العملاقة والمرصوفة كل ثلاثين أو أربعين مترًا في هذه المروج. لكن شيئًا ما يبدو لي غريبًا في هذه الأشجار، لكنني عجزت عن قول أي شيء » (Redfield، 1996 : 58).
في هذا النص، يتجلّى الاستخدام المزدوج للوصف : تصوير المكان وكشف الانفعال النفسي للشخصية في آنٍ معًا. فالسارد لا يكتفي برسم كثافة الغابة، بل يعبّر عن توجّسه وعدم اطمئنانه في هذا الفضاء الغريب. ويظهر ذلك في تعجّبه من الأشجار الضخمة، ومن متانة الحشائش غير المعتادة. إنّ البحث عن النبوءة، كما توحي به الرواية، ليس نزهة استكشافية، بل هو مسار محفوف بالمخاطر والقلق والتوجس.
من هنا، لا تكمن أهمية الوصف في تمثيل المكان الجغرافي وعناصره الطبيعية بحدّ ذاتها، بل في الأثر الذي يتركه هذا التمثيل على سيرورة السرد، وعلى العلاقات المتداخلة بين الشخصيات والأحداث، وكذلك على البعد الروحي للنص. فالمغامرة والبحث عن الغامض يستوجبان اللجوء إلى تقنيات وصفية دقيقة، تُفعّل ما يسمّيه بوعزة بـ« التقاطبات الثقافية والرمزية » (بوعزة، 2010 : 102)، وهي البنيات العميقة التي يشحن بها الكاتب المكان ليصبح علامة دلالية في خدمة الموضوع الرئيسي للرواية.
4.2. الجبل ومصادر الطاقة
تتعلّق بحوث الجغرافيا كذلك بمصادر الطاقة، وأماكن تواجدها وأنواعها. وهنا، في روايتنا المبنية على أسس الجغرافيا الأدبية، استطاع الكاتب أن يذهب إلى اكتشاف مصدر جديد للطاقة، يختلف تمامًا عن المفاهيم الكلاسيكية للطاقة في علم الجغرافيا. وقد أسّس لهذا التصور بأسلوب تنبئي، مدعوم بحجج يغلب عليها الطابع العلمي التقريري.
إنّ اختيار الكاتب للجبل كفضاء رئيس لمغامرات الرواية ليس اعتباطيًا، بل هو اختيار دلالي نابع من وعيه الرمزي بجغرافية النص. فبعد تناوله لموضوع « الصدف »، ينتقل إلى فكرة الطاقة الروحية، بوصفها نبوءة جديدة تكشف عن علاقة الإنسان بالطبيعة وبالآخرين. هذه الطاقة - بحسب الرواية - هي مصدر حيوي خفي، يؤثر في العلاقات بين البشر وفي اتصالهم مع محيطهم.
يرى يوري لوتمان أن
« الإنسان يحاول دائمًا تقريب المفاهيم المجردة من خلال تجسيدها في المحسوسات، وأقرب هذه هي الإحداثيات المكانية؛ فالتفكير يُترجم، والمجردات تتحول إلى محسوسات » (لوتمان، 1987 : 65).
ومن هنا، يتحوّل الجبل إلى استعارة مكانية لتجسيد تلك الطاقة الكونية، التي لا تُرى ولكن تُستشعر.
في الرواية، تقول إحدى الشخصيات :
« النص يتحدث عن القضية الرابعة؛ ويؤكد أن يومًا ما سوف يفهم الإنسان أن العالم يشمل طاقة محرّكة واحدة، تستطيع أن تبقينا أحياء... وبسبب النقص، يحاول الناس مضاعفة طاقتهم الشخصية عبر سرقتها من الآخرين بأسلحة نفسية. وهذا الصراع يفسّر كل التوترات البشرية » (Redfield، 1996 : 93).
ويؤكد السارد :
« الجبال هي المناطق الخاصة التي تستطيع أن تمدّ بالطاقة للذين يحتكّون بها... غابة عذراء مغروسة على جبل، تخلق كثيرًا من الطاقة » (Redfield، 1996 : 108). وفي مقطع آخر : « حين يدرك الناس طبيعة هذا الصراع، سيتجاوزونه... ويكفّون عن سرقة طاقة الآخرين، لأنهم يصبحون قادرين على التقاطها من مصدر آخر » (Redfield، 1996 : 123).
هكذا يتضح أن الجبل في الرواية ليس مجرد ديكور طبيعي، بل هو ركيزة رمزية لفكرة الطاقة التي تُحرّك الوجود وتحكم التوازن بين البشر. فالجبل هو الهواء النقي، والعزلة الهادئة، والسكينة التأملية. وهو ما يجعل السارد يمنحه مكانة مركزية في رؤيته النبوئية.
5.2. الجبل / المكان الأكثر انفتاحًا
يرى يوري لوتمان أن « المكان في الخطاب الروائي لا يُختزل إلى نقطة جغرافية، بل هو شبكة من العلاقات : الاتصال، القرب، الاتساع، الضيق... » (لوتمان، 1987 : 68). وعليه، يصبح المكان بنية رمزية تُستثمر لغويًا وثقافيًا داخل النص.
يفرق النقاد بين المكان الواقعي والمكان السردي :
-
الأول مرتبط بالإحداثيات الجغرافية الملموسة.
-
الثاني فضاء لفظي، ثقافي، وتخيلي، يتشكّل من خلال اللغة.
المكان السردي إذًا هو انعكاس لتصورات الكاتب، ومنظور الشخصيات، وإسقاطات المتخيل الجماعي (بوعزة، 2010 : 99-100).
يقول لوتمان : « اللغة هي المقابل غير المحسوس للمحسوسات؛ تنوب عن الواقع وتمنحه دلالة » (لوتمان، 1987 : 64). ويضيف باشلار : « المكان الذي يمسك به الخيال لا يظل مكانًا محايدًا، بل يصبح مركز جذب دائم، لأنه يركّز الوجود في حدود حتمية » (باشلار، 1987 : 25).
وبناء عليه، يُعدّ الجبل في هذه الرواية مثالاً على المكان المفتوح : فضاء ممتد، حر، لا يُقيد الحركة أو التأمل. من خلال وصف تنقل الشخصيات بين القمم والسهول والغابات، ومن خلال تصوير الأحداث من زوايا متعددة (من الأعلى، من الأدغال، من تحت الأشجار...)، يعيد الكاتب بناء المكان بوصفه كاميرا سينمائية تتحرك بحرية لرصد مسار النبوءة.
في أحد المقاطع : « أعود مرة أخرى إلى الصعود... وصلت إلى قمة الجبل فوجدت نفسي أقف على أرضية مستوية للغاية » (Redfield، 1996 : 131). الاختلاف في الرؤية بين القاعدة والقمة يوظف مبدأ النسبية في الإدراك، وهو ما يتيحه المكان الروائي كإطار تأويلي متحوّل.
ومع كل حركة في الرواية، تكتشف الشخصيات نصًا جديدًا مرتبطًا بالنبوءة. الفضاء الجبلي يتحوّل إلى مسار سردي تصاعدي، يعكس تصاعد الوعي والبحث عن المعنى. وفي النهاية، تترك الرواية الباب مفتوحًا لاكتشاف « النص العاشر » الغامض : « لم نعثر عليه بعد، ولا أحد يعلم أين يتواجد » (Redfield، 1996 : 318).
هنا يتحقق الاندماج الكامل بين المكان، الفكرة، والسرد؛ فالنص يصبح هو الجبل، والقراءة رحلة صعودٍ فيه نحو المعنى.
الخاتمة
تتلخص خاتمة بحثنا هذا في جملة من النتائج أهمها :
تأسست العديد من الروايات المحلية والعالمية على فضاء الجبل، وكثيرًا ما ارتبط هذا الاختيار بموضوعات مختلفة كالطمأنينة والكبرياء والمغامرة والتحدي، وهو الفضاء الذي يمنح تلك الموضوعات ديناميكية سردية تعزّز من العلاقات الضرورية بين العناصر السّردية المتنوعة في الخطاب الروائي، كالشخصيات، الزمن، الأحداث، والمكان.
اختار جيمس ريدفيلد جبال الأنديز الواقعة في غرب أمريكا الجنوبية لتجسيد تصوراته وتخييلاته المتعلقة بالنبوءة الجديدة، والنصوص التي كانت الشخصية الرئيسة في الرواية تسعى لاكتشافها. ويعود هذا الاختيار إلى عاملين : أوّلهما غياب المعتقدات الدينية أو الكونية النابعة من الغرب، إذ جلها ظهر في الشرق، وثانيهما ارتباط هذه المعتقدات غالبًا بالفضاءات الجبلية المعزولة التي تُتيح الانفصال عن العالم المرئي، كالمغارات والغابات والكهوف.
تنتمي هذه الرواية إلى الجغرافيا الأدبية، إذ تمكّن الكاتب من إدخالنا في عالم مكاني جغرافي حيّ ومفصّل (جبال الأنديز)، زاخر بعناصر الجغرافيا من تضاريس ومناخ وطبيعة، ومشحون بدلالات إنسانية وروحية من خلال اللغة السردية. وقد نجح في إضفاء بُعد تخييلي ورؤيوي على هذا المكان، عبر إدماجه بفكرة نبوءة مستقبلية شاملة، في ظل عالم متحوّل ومأزوم.
إنّ سيرورة السرد المتعلق بهذه النبوءة تحتاج إلى فضاء زمني ومكاني متسع، وإلى حركة سردية مستمرة، وأبعاد تاريخية وثقافية وفلسفية، تستلهم المعتقدات الروحية وتستدعي تفكيرًا تأويليًا عميقًا حول مصير الإنسان. فالنص مبني على رحلة فكرية لا تقل أهمية عن رحلته الجغرافية.
اتسمت الرواية بنزعة فلسفية ورؤيوية واضحة، لذلك كان اختيار الجبل موفقًا، باعتباره مصدرًا للطاقة الروحية والمعرفية، وفضاءً للتأمل والسكينة. كما أنه المكان الأكثر انفتاحًا على التفكير الحر والمجرد، وعلى بروز التصورات الميتافيزيقية.
أما السرد القائم على فضاء الجبل، فإنه يفتح النص على إمكانات غير محدودة من الأحداث والعجائب والمفاجآت، مما يمنح الكاتب حرية بناء عالم تخييلي مرن، قادر على استيعاب الأساطير والتأويلات والرموز. وهكذا، يتحول النص نفسه إلى جبل متعدد الطبقات، وعلى القارئ أن يصعده لاكتشاف معانيه.